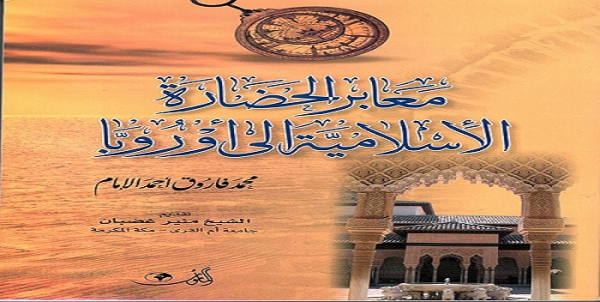محمد فاروق الإمام – مركز أمية للبحوث والدراسات الاستراتيجية
الكتاب من تأليف الكاتب محمد فاروق الإمام، وصادر عن دار المأمون للنشر والتوزيع عام 2008 وهو من الحجم المتوسط ويضم بين دفتيه 240 صفحة، وقد اعتمدته هيئة التعليم في سلطنة عمان في مناهجها، (كما أخبرني الدكتور مأمون فريز جرار صاحب دار النشر التي طبعت الكتاب).
ويبدأ الكتاب بتقديم من فضيلة الشيخ منير غضبان الأستاذ في جامعة أم القرى-مكة المكرمة، ومن ثم مقدمة المؤلف، وعلى ظهر مجلد الكتاب كلمة الناشر الدكتور مأمون فريز جرار.
وقد وزع الكاتب مؤلفه على ثمانية فصول، الفصل الأول تحدث فيه عن معابر الحضارة الإسلامية إلى أوروبا عبر بلاد الشام وصقلية والأندلس، وفي الفصل الثاني تحدث عن العلوم التي أخذها الغرب من المسلمين العرب في الأدب والفلسفة، وفي الفصل الثالث تحدث عن الرياضيات والفلك التي تعلمها الغرب من العرب، وفي الفصل الرابع تحدث عن الجغرافيا والطبيعة والكيمياء وما وصل إليه العرب من التقدم في هذه العلوم، وفي الفصل الخامس تحدث عن الطب، وفي الفصل السادس تحدث عن المسجد وتعلم القراءة والدين والعلم (منازل العلماء ومجالسهم، دور القرآن ودور الحديث، والمدارس والجامعات والمكتبات)، وفي الفصل السابع تحدث عن الصناعة، وختم بالحديث في الفصل الثامن عن القيم والأخلاق.
يقدم هذا الكتاب فصولا مشرقة من الحضارة الإسلامية التي لم يستأثر المسلمون بها، بل قدموها للإنسانية كلها، وكانت أوروبا المستفيد الأول منها، من خلال معابر الحضارة في الشرق إبان الحروب الصليبية، وفي صقلية، والأندلس. وكل ما في هذا الكتاب يشير إلى لؤم الغرب الحاقد، ويتغنى بفضل المسلمين عليه، وقد شملت فصول هذا الكتاب معابر الحضارة الإسلامية العربية إلى الغرب، والعلوم التي أخذها الغرب عن المسلمين، عبر المؤسسات الثقافية الإسلامية، ومدى تأثر جامعات الغرب بالجامعات الإسلامية. وتوخى المؤلف الموضوعية العلمية في استنباط معلوماته من مصادر شتى؛ طلبا للحقيقة دون مبالغة، وركز بشكل واضح على ما كتبه الغرب وفلاسفته ومفكروه ومستشرقوه، واعترافاتهم بفضل الإسلام والمسلمين على الغرب فيما ينعم به الآن من تقدم وعلوم ومدنية.
وقد جاء في تقديم الشيخ منير غضبان قوله: “متعة روحية خالصة، وأنا أتجول في عباب التاريخ مع أخي محمد فاروق الإمام الذي أخذ بيدي في أبهاء العصور الماضيات الخالدات، ليطلعني على مشرق حضارة الغرب، وأنها ما كان لها أن تشرق إلا من المشرق الإسلامي، وأن أفولها سيكون من الغرب، لأن علائم سقوطها لم يعد سراً يذاع، ولا خبراً يلقى، إنما ظاهرة تدرس ويتداعى عقلاء الغرب لمعالجة البناء قبل الانهيار، ولم يدعني أخي فاروق إلا وتجول بي في كل صقع وكل واد مع فن من فنون حضارتنا الإسلامية، بحيث كدت أعتب عليه أنه لم يسر بي في أعظم ما قدمه الإسلام للبشرية، وهي شريعة العدل والرحمة المهداة للبشرية، لولا أن تدارك الأمر، فكانت آخر جولاته مع أثر الحضارة الإسلامية في الحضارة الغربية في مجال القيم والأخلاق.
وجاء في مقدمة المؤلف:
من رحم المعاناة التي نعيشها كمسلمين وعرب، رحت أبحث عن الدوافع التي تجعل الغرب يفعل بنا ما يفعله على مستوى الإنسان والأرض، واستغرق بحثي هذا فترة طويلة عشت نهارها وليلها مع صفحات ما كتب قديماً وحديثاً حول العلاقة التي قامت بين المسلمين العرب وبين الغرب، من بداية الفتح الإسلامي العربي لبلاد الشام ومصر، وحتى خروجهم من الأندلس (إسبانيا حاليا).
وركزت خلال مطالعتي على ما كتبه أبناء الغرب عن تلك الفترة من حياة العلاقات بين الأمم، ومن بينها علاقة الحضارة الإسلامية العربية بالغرب، فوجدت العجب العجاب مما قدمه العرب -الذين أفاء الله عليهم بنور الإسلام -من خدمات جُلّى ومن أيادٍ بيضاء أزاحت ظلمة الليل الطويل عن حياة أوروبا بفضل ما قدموه لهم من علوم ومعارف شملت كل مناحي الحياة من إنسانية ورياضية وفلكية وطبية وفنية وخُلقية وفروسية.
وراحت أوروبا -بفضل هذه العلوم وهذه المعارف -تنفض عن كواهل شعوبها غبار التخلف والجهل، وتزيل كوابيس ظلم الإنسان للإنسان، وَتفشّي الخُرافة والسحر والشعوذة، وتقف في وجه الصلف الكنسي ورجالاته الذين تبلدت عقولهم عن فهم المعاني العظيمة التي جاء بها السيد المسيح عليه السلام، الذي كان يُحرِّم كتم أنفاس الناس والحجر على عقولهم. ولكن -ويا للأسف الشديد-بدلاً من أن يكافئ الغرب المسلمين العرب على ما قدموه لهم من علوم ومعارف وخدمات ساعدتهم على الخروج من ظلمة النفق الطويل الذي عاشوا فيه لقرون طويلة لينعموا بفوائد هذه العلوم وهذه المعارف ردحاً طويلاً من الزمن، امتد من بداية القرن السابع الميلادي وحتى أوائل القرن الثامن عشر الميلادي. أقول – ويا للأسف الشديد – كانت مكافأة الغرب للمسلمين على هذه الخدمات الجلّى التي قدموها لهم، كمكافأة (النعمان لسنمار).
لقد مدَّ الغرب للمسلمين العرب أيدٍ وبها سكاكين مشحوذة يمزقون بها أوصالهم، ويقطّعون بها أرضهم، ويسلبون بها خيرات أوطانهم، ويحيكون بها المؤامرات للفتك بهم أنى استطاعوا إلى ذلك سبيلا، من بداية القرن السادس عشر الميلادي وحتى اليوم عبر محاكم التفتيش التي أقاموها لهم في الأندلس، وحملات الاحتلال البرتغالي والفرنسي والإنكليزي والإسباني لبلادهم، ومن ثم الاستعمار الطويل الذي جثم الأوروبيون من خلاله على صدر هذه الأمة، وأحالوها إلى شذر مذر، يمتصون خيرات أرضها، ويعبثون بعقول أبنائها فساداً، زارعين في صفوفهم النزاعات والشقاقات والخلافات العرقية والإقليمية والقطرية والدينية والمذهبية والطائفية، ولا يزال الغرب يتحكم بهذه الأمة بعد أن زرع في قلبها وطنا مغتصبا لليهود في فلسطين، وتمكن من تمزيق الراية المسلمة الواحدة – عندما تقاسم بموجب اتفاقية (سايكس بيكو) أراضي الدولة العثمانية، فيما قام أحد من تربوا على عيونه (أتاتورك) بإلغاء الخلافة العثمانية – تلك الراية التي قادت مشاعل النور لتزيل دياجير الظلمة عن أوروبا – كما سماها ملك إنكلترا عندما بعث بابنة أخيه على رأس بعثة إلى الأندلس لتنهل من علوم العرب المسلمين – وتبدد عن شعوبها ظلمة التخلف والانحطاط، وتخرجهم من أقبية العبودية والشعوذة إلى فضاء الحرية والعزة والكرامة.
أما ما جاء في كلمة دار المأمون للنشر التي طبعت الكتاب، فقد ذيله مدير الدار الدكتور مأمون فريز جرار قائلا: “يخطئ من يعرض الوجه السياسي لتاريخنا فيشوه كثيراً من صفحات هذا التاريخ المليء بالصفحات المشرقة؛ علماً وحضارة، وقيماً إنسانية، لم نعرف البشرية لها مثيلاً.
وهذا الكتاب القيم الأستاذ محمد فاروق الإمام يقدم فصولاً مشرقة من سفر الحضارة الإسلامية التي لم يستأثر المسلمون بل قدموها للإنسانية كلها، وكانت أوروبا المستفيد الأول منها من خلال معابر الحضارة في الشرق إبان الحروب الفرنجية (الصليبية) وفي صقلية وفي الأندلس.
قارئ هذا الكتاب القيم سيجد فيه الجديد الذي يجعله يثق بماضينا ويسترد ثقته بواقعنا ويشرقُ لديه الأمل في مستقبلنا.
وفي دراسة للباحث السنوسي محمد السنوسي نشرها موقع إسلام أون لاين عن حالة أوروبا والظلام والجهل والتخلف الذي كان يعيشه خلال القرون الثمانية التي تصدر فيها المسلمون مسيرة الحضارة، يؤكد على ما جاء في هذا الكتاب.
يقول السنوسي: “كانت أوروبا تعيش ما عُرف بقرونها الوسطى المظلمة. وقد شهد كثير من المستشرقين على الفجوة الحضارية العميقة التي كانت تفصل بين المسلمين وأوروبا في هذه الفترة؛ فبينما كانت الأخيرة تتخبط في الوحل نهارًا والظلام ليلاً، كانت شوارع وأسواق العرب في الأندلس مرصوفة وتضاء ليلاً. وكان كثير من الأوروبيين يوفدون أبناءهم ليتعلموا في المعاهد العربية وخاصة معاهد الأندلس؛ وكان ذلك حتى في عصر متقدم على العصر الذي بدأ فيه العلم العربي يغزو أوروبا ليبدد جهالات القرون السود. ففي القرن العاشر كان من بين الذين وفدوا من أوروبا لتلقي العلم في المعاهد العربية بالأندلس راهب يدعى جربير؛ فأجاد العربية، وحصل على المعارف العربية ثم أصبح فيما بعد بابا روما (من 999 إلى 1003م.) تحت اسم “سلفستر الثاني”. ولقد عُرف في التاريخ العصرُ الذي بدأت فيه ترجمة العلوم من العربية إلى اللاتينية-وهو القرنان الثاني عشر والثالث عشر-بعصر الحركة العربية الهامة في أوروبا. ويكاد يتفق المؤرخون أن انتقال العلوم والثقافة الإسلامية إلى أوروبا-وهو الانتقال الذي مهد لما عُرف بـ”عصر النهضة”- كان من خلال ثلاثة معابر أساسية: أولاً: صقلية وجنوبي إيطاليا أخذ العرب في غزو جزيرة صقلية منذ عام 827م. واستولوا على الجزيرة كلها عام 878م. وأخذوا ينشرون حضارتهم في ربوعها حتى انحسر عنها سلطانهم سنة 1092م. على يد ملوك النورمانديين، الذين لم يكونوا أقل من حكام العرب تسامحًا في الدين، وكفالة للعلم، ورعاية لأهله. وفي مقدمة هؤلاء “روجار الثاني” الذي حكم بين سنتي 1130 و1154م. واقترن اسمه بأكبر جغرافي عربي هو “الشريف الإدريسي”؛ ثم حفيده “فردريك الثاني” الذي استبد به الإعجاب بحضارة العرب فتشبه بهم في عاداته وأساليب حياته، وكان يقرأ كتبهم في أصولها؛ لأنه كان ملمًا بالعربية إلى جانب الألمانية والفرنسية والإيطالية واللاتينية واليونانية. وقد أنشأ عام 1224م. جامعة “نابلي” لنقل العلم العربي إلى العالم الغربي؛ وسرعان ما أضحت مركز الاهتمام بالثقافة العربية، وفيها وضعت ترجمات مختلفة من العربية إلى اللاتينية والعبرية، وبتشجيعه زار “ميخائيل سكوت” طليطلة عام 1217م. ونقل الكثير من الكتب العربية. ثانيًا: الأندلس عبر المسلمون إلى اسبانيا عام 709م. ولم ينحسر سلطانهم عنها إلا بسقوط آخر مملكة عربية في غرناطة سنة 1492م-أي بعد خروج المسلمين من صقلية بأربعمائة سنة تمامًا-وخلال هذه القرون الثمانية انتشرت الحضارة الإسلامية المزدهرة في ربوع البلاد، وتركت بصماتها على كل نواحي الحياة، معنويًّا وماديًّا. ويقدم “غوستاف لوبون” شهادة مفصلة عن التأثير العميق الذي خلَّفه المسلمون في الأندلس، كمثال؛ سواء في الناحية الثقافية بإشاعة التسامح، ورعاية المخالفين في الفكر والعقيدة، وإقامة المكتبات والمدارس؛ أو الناحية المادية بتشييد الأبنية والمساجد (مسجد قرطبة) والقصور (قصر الحمراء) والحدائق، التي مازالت شاهد صدق حتى الآن على عظمة هذه الحضارة وروعتها. يقول “لوبون”: “استطاع العرب أن يحولوا اسبانيا ماديًّا وثقافيًّا في بضعة قرون، وأن يجعلوها على رأس جميع الممالك الأوروبية؛ ولم يقتصر تحويل العرب لإسبانيا على هذين الأمرين، بل أثروا في أخلاق الناس أيضًا، فهم الذين علموا الشعوب النصرانية، وإن شئت فقل: حاولوا أن يعلموها التسامح، الذي هو أثمن صفات الإنسان. وبلغ حِلمُ عرب اسبانيا نحو الأهلين المغلوبين مبلغًا كانوا يسمحون به لأساقفتهم أن يعقدوا مؤتمراتهم الدينية، كمؤتمر أشبيلية النصراني الذي عقد في سنة 782م. ومؤتمر قرطبة النصراني الذي عقد في سنة 852م. وتعد كنائس النصارى التي بنوها أيام الحكم العربي من الأدلة على احترام العرب لمعتقدات الأمم التي خضعت لسلطانهم”. وفي كلمات عميقة الدلالة، يشهد “لوبون” أن “همجية أوروبا البالغة”-حسب تعبيره- قد دامت “زمنًا طويلاً من غير أن تشعر بها؛ ولم يَبْدُ في أوروبا بعضُ الميل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر وفي القرن الثاني عشر من الميلاد؛ وذلك حين ظهر فيها أناس رأوا أن يرفعوا أكفان الجهل الثقيل عنهم، فولّوا وجوههم شطر العرب، الذين كانوا أئمة وحدهم”. كما يكرر “لوبون” تلك الشهادة في موضع آخر، وكأنه يريد أن يسكت من يلوكون الاتهامات الباطلة ضد الحضارة الإسلامية، ويرمونها بما هي منه بَرَاء، فيقول: “إن العرب هم الذين فتحوا لأوروبا ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية والأدبية والفلسفية بتأثيرهم الثقافي؛ فكانوا مُمدِّنين لنا، وأئمةً لنا ستة قرون”. ثالثًا: الحروب الصليبية لقد سمحت الحروب الصليبية طوال القرنين اللذين تواصلت فيهما (1097- 1291م)، بأن يطلع الأوروبيون على الحضارة الإسلامية في نواحي الفنون العسكرية، والعمارة، والزراعة، والصناعة، والحياة الاجتماعية؛ حتى كانت بعض طبقات الصليبيين تفرض على نسائها وأبنائها إذا بلغن الحُلم أن يضربن الخمار على وجوههن، ويأبون عليهن أن يخرجن إلى الأسواق سافرت، بل إنهم ما كانوا يسمحون لهن بالخروج إلا للضرورة القصوى، كالذهاب إلى الكنائس والحمامات؛ كما أطلق بعض الرجال الصليبيين اللحى، تشبهًا بالمسلمين. ولذلك يؤكد لوبون أن “اتصال الغرب بالشرق مدة قرنين [خلال الحروب الصليبية] من أقوى العوامل على نُموِّ الحضارة في أوروبا”. ولكنه يعود فيفرِّق في الأثر الذي تركته تلك الحروب على أوروبا، فيرى أن “تأثير الشرق في تمدين الغرب كان عظيمًا جدًّا بفعل الحروب الصليبية، وأن ذلك التأثير كان في الفنون والصناعات والتجارة أشدَّ منه في العلوم والآداب. وإذا ما نظرنا إلى تقدم العلاقات التجارية باطِّراد بين الغرب والشرق، وإلى ما نشأ من تحاكِّ الصليبيين والشرقيين من النمو في الفنون والصناعة؛ تجلَّى لنا أن الشرقيين هم الذين أخرجوا الغرب من التوحش، وأعدوا النفوس إلى التقدم بفضل علوم العرب وآدابهم التي أخذت جامعات أوروبا تعول عليها؛ فانبثق عصرُ النهضة منها ذات يوم”. إذن، استطاعت الحضارة الإسلامية أن تؤثر فيمن جاورها من الأمم وتأخذ بأيديهم على مدارج السلم الحضاري، وأن ترسل أشعة نورها وعمرانها إلى أوروبا عبر ثلاثة معابر؛ بما مهَّد للقفزة الهائلة في العلوم التجريبية، وتأسيس نهضة الغرب في العصر الحديث؛ مما يؤكد أن الحضارة في جانبها المادي والعمراني سلسلةٌ متصلة الحلقات، ينبني اللاحقُ منها على السابق، وتسهم فيها كلُّ أمة وحضارة بنصيبها. وعلى الرغم من أن معظم الكتابات الأوروبية أسقطت من تاريخها دورَ الحضارة الإسلامية؛ الذي كان أكبر من كونه مجرد “همزة وصل” بين الحضارة اليونانية والنهضة الغربية الحديثة؛ حيث استوعب المسلمون علوم من سبقوهم، ونقَّحوها، وأضافوا إليها الشيء الكثير، أقول: رغم هذا الإجحاف والإنكار، فإن ثمة مستشرقين منصفين- أشرنا إلى بعضهم- شهدوا بعظيم الدور الذي قامت به الحضارة الإسلامية، وأكدوا أنه “لو لم يظهر العرب على مسرح التاريخ، لتأخرت نهضة أوروبا الحديثة عدة قرون”.
المصدر
*إسلام أون لاين-السنوسي محمد السنوسي