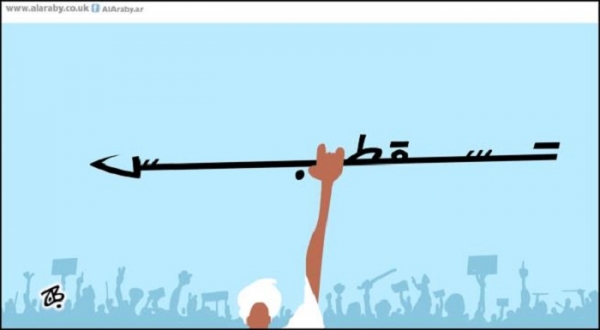د.بدر شافعي
كلما تمر الأيام في السودان بعد إطاحة عمر البشير، تتكشف الأمور والمواقف شيئا فشيئا، وقد يساعد هذا الانكشاف في فهم مجريات الأحداث، لكنه قد يزيد المشهد تعقيدا، فربما كان البشير قمة جبل الجليد، التي بمجرد سقوطها، بدأت الأمور تتضح شيئا فشيئا، لا سيما أن الحديث الآن بات يركز على تفاصيل المرحلة الانتقالية التي ربما تشهد تبايناتٍ حتى داخل الفصيل الواحد بشأن مفرداتها، وكما يعرف دائما، فإن الشيطان يكمن في التفاصيل.
أول تعقيدات المشهد الراهن تتمثل في تشكيلة الطرفين الأساسيين الآن، وهما قوى الحرية والتغيير التي تضم بداخلها قوى “نداء السودان” و”الإجماع الوطني” و”تجمع المهنيين” وغيرها، في مقابل المجلس العسكري الانتقالي الذي يتشكل من عشرة أشخاص، كلهم ينتمون للمؤسسة العسكرية باستثناء واحد أو اثنين من المؤسسة الأمنية. تشكيلة كل من الطرفين هذه، مع وجود أطراف أخرى غير منضوية لقوى الثورة (أكثر من مئة حزب في السودان بغض النظر عن فاعلية دورها) تعد أحد تعقيدات المشهد ذاته، فقوى الحرية والتغيير تضم قوى غير مسيسة، تتمثل في تجمع المهنيين الذي قاد الحراك الثوري منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومعظمهم من الشباب التكنوقراط غير المسيس، والذين يعدّون أيقونة الثورة. تقف هذه القوى جنبا إلى جنب مع قوى أخرى سياسية تقليدية، ربما كانت تطمح تاريخيا في السلطة، حتى وإنْ بالاستعانة بالعسكر، كالقوى الشيوعية ودعمها انقلاب جعفر النميري ذي التوجهات اليسارية في مايو/ أيار 1969، أو قوى سياسية كحزب الأمة الوطني الذي قاد الحكومة في مرحلتي ما بعد الفريق إبراهيم عبود (بدأت في 1958) والنميري، لكنه ساهم، بصورة أو بأخرى، في حدوث انقلاب عسكري بعد خمس سنوات فقط، بل إنه كان مؤيدا من خلال رئيس وزرائه، عبدالله خليل، انقلاب عبود للتخلص من خصوم الحزب… وبالتالي بات السؤال: من ستكون له اليد الطولى داخل قوى التغيير، هل لهؤلاء الشباب الذين يفتقدون الخبرة السياسية، أم للشيوخ الذين ربما أفسدوا التجارب الديمقراطية المحدودة التي شهدتها البلاد.
ثم يأتي تعقيد آخر يتعلق بمدى تمثيل قوى الحرية والتغيير قوى الثورة، وربما هذا ما فطن إليه
المجلس العسكري الانتقالي، ويلعب عليه الآن، إذ يرى أن المرحلة الانتقالية لا بد أن تتم بمشاركة الجميع، وربما الاستثناء، بسبب ضغوط الثوار عليه، حزب المؤتمر الوطني، الحاكم سابقا. ولذلك استقبل قوى الحرية والتغيير، ثم باقي القوى الأخرى، وأكد أنه سيتلقى المقترحات بشأن رئيس الحكومة المدنية المقترحة من الجميع، ما يعني السماح لكل طرف، حتى من الأطراف الموالية له بتقديم مقترحات، وبالتالي تشتيت الجهود، واللعب على الخلافات لإضعاف الخصوم، متأثرا بذلك بالتجربة المصرية إبّان ثورة يناير، والتي لعب دورها الأساسي رئيس المخابرات العامة الراحل عمر سليمان، ومدير المخابرات الحربية في حينها عبد الفتاح السيسي.
ويتعلق التعقيد الثالث بالمجلس العسكري الانتقالي وكيفية اختياره، فالواضح أنه امتداد لنظام البشير. وقد برز هذا بوضوح بعد الإعلان الأول لوزير الدفاع ونائب الرئيس عوض بن عوف، والذي على الرغم من الرفض الشعبي لبيانه، وله شخصيا، إلا أنه أصرّ على تنصيب نفسه رئيسا. ولما زادت الضغوط، اختار المجلس شخصا آخر، هو عبدالفتاح البرهان، من دون معرفة كيفية اختياره، ناهيك عن أنه أيضا أحد رجال البشير الذي قام بترقيته في فبراير/ شباط الماضي من فريق ركن إلى فريق أول، وإسناد منصب المفتش العام للقوات المسلحة إليه، بعد أن كان قائدا للقوات البرية، كما أسند له الإشراف على القوات السودانية في اليمن، بالتنسيق مع نائبه، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي، الذي، وإن أظهر، هو الآخر، تعاطفا وتأييدا للمطالب الشعبية، سيما ما يتعلق بتقليص المرحلة الانتقالية، إلا أنه كان قائد مليشيا الجنجويد في حرب دارفور، ثم قائد قوات الدعم السريع التي كانت ذراع النظام الطولى في ملفي كردفان والنيل الأزرق وغيرهما.
وهنا تأتي إشكالية خاصة بعلاقة كلا الجانبين، قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، ببعضهما، فتبرز أزمة ثقة عميقة، ربما لن تخفف منها الكلمات الدبلوماسية “الناعمة” من المجلس العسكري، فمن وجهة نظر قوى التغيير، لا بد من التغيير الشامل لكل مؤسسات الدولة. ووفق ما جاء في البند الرابع من إعلانها في يناير/ كانون الثاني الماضي، والذي يعد الإطار المرجعي لمواقفها، فإنها تطالب بإعادة هيكلة مؤسسات الخدمة المدنية (الشرطة)، والعسكرية (الجيش) خلال المرحلة الانتقالية، وهو ما أكد عليه ميثاق إعادة الهيكلة الذي تم توقيعه في إبريل/ نيسان 2016 بين قوى نداء السودان والإجماع الوطني والجبهة الثورية ومبادرة المجتمع المدني، والذي اعتبرته قوى الحرية والتغيير إطارا مرجعيا ثانيا لها، فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية المقبلة، إذ ينص أيضا على حل (وتسريح) الدفاع الشعبي ومليشيات الدعم السريع وجميع المليشيات التي أنشأها النظام ونزع أسلحتها.
تساهم هذه المواقف في تعميق أزمة الثقة بين الجانبين، وتجعل المجلس العسكري رافضا مطلب
هذه القوى بوجود تمثيل مدني في صفوفه، حتى وإن كان تمثيلا محدودا، لا يؤثر على اتخاذ القرارات، كما تجعله هدفا صريحا لهذه القوى، فكيف سيكون حال حميدتي، وهو نائب رئيس المجلس، عندما يطالب الثوار بحل قواته، بل وربما هذا هو الأخطر تقديمه، هو وأعضاء المجلس للمحاكمة الوطنية والمحلية، على جرائم ارتكبت في الفترة الماضية بحق المدنيين. وقد جاء هذا الأمر أيضا في بيان إعادة الهيكلة في البند الثالث الخاص بالعدالة الانتقالية، إذ تم التأكيد على إخضاع مرتكبي الجرائم للمحاكمات العادلة، ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، بالمحاسبة الوطنية والدولية على ارتكاب الجرائم الجسيمة، وفي مقدمتها جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
صدور مثل هذه البيانات بهذا الوضوح لا يجعل العسكر يرفض فقط فكرة مشاركة المدنيين، بل وربما يجعله يسعى، بطريقةٍ أو بأخرى، إلى الالتفاف حول الثورة، مهما بدا منه غير ذلك، بسبب هذا الخطاب الواضح والصريح. ولعل هذا يفسّر أسباب حرصه على تقليص المرحلة الانتقالية إلى سنتين حدا أقصى، بدلا من أربع وفق الثوار، لأنه يدرك أن هذه المدة ربما تكون قصيرة على الثورة والثوار الجدد لإعادة ترتيب الحياة السياسية وغيرها، والتي تحتاج مزيدا من الوقت، في حين أن قوى “المؤتمر الوطني” والثورة المضادة ستكون في عنفوانها، وستعيد تجهيز نفسها بصورة أو بأخرى. وبالتالي، يمكن أن تعود إلى المشهد بلباس ديمقراطي، مستغلة حالة التخبط، أو عدم النضج لهذه القوى، في المرحلة الانتقالية.