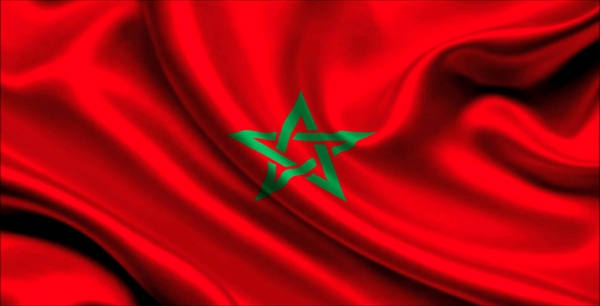لابد في هذه اللحظة السياسية التي تمهد لأوضاع جديدة يقبل عليها المشهد السياسي المغربي بعد أشهر قليلة، أن نقول في الدولة وإدارتها للمرحلة الماضية قولة منصفة، فقد سلكت الدولة اختيارات سياسية واجتماعية عقلانية قبل خمس سنوات عندما قررت أن تقرأ التحولات الإقليمية وتأثيراتها على مستقبل المغرب بهدوء، وكان موقفها متوازنا فلم تقع بعد ذلك في تعاملها مع الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ومع تلك التجربة في فخ الاستقطاب السياسي والاجتماعي الذي عرفته المنطقة لاحقا، وانتشرت تداعياته التي دمرت أو تكاد بنى سياسية واجتماعية واقتصادية لعدد من دول المنطقة.
الدولة ليست وجهة نظر واحدة ولم تكن يوما ما كذلك، ويوجد بداخلها تمثلات وتوجهات قد تتفق أو تختلف في تصوراتها لما ينبغي أن يكون عليه المغرب سياسيا واقتصاديا، وللقوى التي يفترض أن تتولى إدارة البلاد، لكنها في المحصلة ساهمت في بقاء تجربة الخمس سنوات الماضية رغم كل ما يمكن أن يقال أو يذكر من السلبيات التي قد تُنسب لبعض المؤسسات وسلوكها، وقد كان باستطاعتها أن تتحول إلى خصم لتلك التجربة كما تحول غيرها، وأن تعمل على إنهائها عوضا عن التعامل معها واستيعابها.
هنالك دائما حاجة تاريخية وحاضرة ومستقبلية للمغرب أن تبقى الدولة محافظة على موقعها فاعلا أساسيا و محوريا في المشهد السياسي. لكن محوريتها لم تخنق السياسة والسياسيين في الخمس سنوات الماضية، فقد اتسعت مساحات كانت ضيقة في الماضي.
لقد ساهمت الدولة في صناعة الاستثناء المغربي عام 2011 والذي يمكن اعتباره سياسيا وزمنيا " الاستثناء الأول" فقد جاء في سياق تحولات سياسية واجتماعية هائلة عرفتها المنطقة العربية، تحولات أكرهت العديد من الأنظمة على الرحيل أو الدخول في مواجهات وحلول دموية، اختلط فيها معنى الثورة والثوار، وباتت حتى الأنظمة القمعية تدعي أنها تمثل الثورة الأصلية. بينما اختارت الدولة المغربية خيارا آخر لا يقل ثورية من الناحية التحليلية إذا أخذنا بمفهومي الثورة البناءة مقابل الثورة الهدامة للأسس الاجتماعية والاقتصادية للدولة. وفي تصوري بعد الاستثناء الأول الذي جاء في ظروف فيها إكراهات كبيرة، تجد الدولة الآن نفسها ولمرة أخرى في وضع اختيار الدخول أو عدمه في إنجاز " الاستثناء الثاني" وأقصد به إدارتها العقلانية لمحطة انتخابات أكتوبر القادم وما بعدها، لأهميتها الكبيرة في صناعة وجهة المغرب القادمة سياسيا واقتصاديا، وأهم من ذلك مدى تماسك بنية المشهد السياسي واستقراره على قواعد سياسية أكثر ثباتا.
لقد تخلصت الدولة رفقة باقي الفاعلين السياسيين من كل الإكرهات أو إذا شئنا تجاوزت المهددات السياسية والاجتماعية الكبيرة التي واجهتها عام 2011، وفرضت عليها عددا من التغييرات على سلوكها السياسي. وبات عقلها متحررا الآن لترى الأمور بشكل أكثر عقلانية وتوازنا من ذي قبل، وهي تدير مرحلة حساسة تسبق الانتخابات القادمة، وكما يعني تجاوزها لامتحان الإعداد لانتخابات أكتوبر أن عقلانيتها باتت أقرب إلى أن تصبح في مستوى " التقليد السياسي"، فإنها بغير ذلك يكون سلوكها مازال مستمرا في كونه مجرد إجابات سياسية مرحلية سرعان ما تنهار في أقرب مناسبة.
ينتظر الدولة قبل امتحان السابع من أكتوبر أن تواجه تحديا مطروحا عليها وعلى سلوكها، بما يجنبها ويجنب المشهد السياسي أي انتكاسة وتراجع عن المكتسبات التي تحققت، أو خيار العقلنة والاستمرار في دعم المسار الإصلاحي، الذي هو إصلاح لذاتها. باستطاعة الكثيرين أن يعدوا الإخفاقات والسلبيات التي طبعت الخمس سنوات الماضية من ناحية تنزيل مضامين الدستور على سبيل المثال، أو النواحي الأخرى التي لم تنل حظها المطلوب من الإصلاح. لكن القليلين هم من يستطيعون قراءة حجم وأهمية الإصلاحات البسيطة ضمن مسار التطور التاريخي ذي الوتيرة البطيئة، لا ضمن حركة التغيير بمعيار ومقياس المتابعة اليومية.
تحقق الاستقرار السياسي والاجتماعي في الخمس سنوات الماضية، وظهر للجميع كيف تلتقي إرادة الدولة وباقي الفاعلين السياسيين عند هذه النقطة المحورية في الاجتماع السياسي المغربي. لكن من الناحية السياسية لم يعد الحديث عن الاستقرار على أهميته هو حجر الزاوية فقط في الخطاب السياسي المغربي، فقد أدى هذا العنصر دوره بفاعلية كبيرة في ضبط إيقاع المشهد الداخلي وتوجيه بوصلته. وبات عقل الدولة السياسي مطالبا بالإجابة عن أسئلة كبيرة للمرحلة القادمة، هل سوف تستمر الدولة في إكمال الإنجازات التي تحققت؟ وهل مازالت الدولة مقتنعة بضرورة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، أم أنها تعتبر الذي تحقق كافيا لطي الصفحة؟ وهل مازالت تنظر إلى الفاعلين السياسيين بشكل متوازن؟ والسؤال الأهم، هل تريد الدولة أن تنتقل بالمشهد السياسي إلى مستوى إيجاد " التقاليد السياسية" أم لا؟
في السياسة مهما تحقق من إنجازات فإن الصفحات لا تطوى، والتجارب الناجحة لا ينبغي اعتبارها حلا للعودة للوراء، والنجاح ليس مقدمة للفشل، والدول التي حققت ولو حدا أدنى من الإنجاز لا تضحي به في أقرب محطة.
في علاقته بالدولة بنى حزب العدالة والتنمية " شرعيته الأولى " عام 2011 على منجز " الاستقرار " الذي ساهم فيه هو كما ساهم فيه غيره، لكن بعد خمس سنوات بات منطق التطور السياسي يفرض على هذا الحزب تجاوز الحديث عن شرعيته الأولى، والدخول في مرحلة " الشرعية الثانية " وهي مرحلة " شرعية الإنجاز". فالحد الأدنى من الإصلاح السياسي والاقتصادي يعتبر إنجازا في هذه المرحلة عندما نقرأه ضمن مسار حركة التاريخ والمجتمع، ويعتبر إنجازا بالنظر إلى الاتجاهات الانتكاسية والتراجعية سياسيا واقتصاديا لدول الجوار والإقليم بشكل عام.
حتى اللحظة ما تزال الدولة لم تضع لنفسها حدودا ومسافات محسوبة ومعروفة تجاه المشهد السياسي، وهو ما يسبب لها أرقا إزاء وضعية حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يولد لكي يكون في المعارضة، وليست لديه لا الرغبة ولا القدرة على الاستمرار فيها في حال خسارته، وهو وضع لا ينبغي أن يدفع بها إلى الحلول غير الصحيحة.
وتزداد المسألة تعقيدا لأن الواقع قد أفرز بعد الخمس سنوات الماضية من التجربة الحكومية حصانا رابحا، حيث تفترض عقلانية الدولة ومنطقها البرغماتي عدم التخلي عن الحصان الرابح. والحصان الرابح لا يخرج من السباق. أما باقي الخيول الأخرى التي ربما قد تكون جميلة أيضا فيمكن المقامرة عليها، لكن تاريخها القريب لا يشهد بقدرتها الميدانية وكفائتها. وبالنهاية هنالك خيول للسباق والجري، وأخرى لمجرد جر العربات أو استعراض المواصفات.
كمال القصير: باحث ومسؤول منطقة المغرب العربي في مركز الجزيرة للدراسات